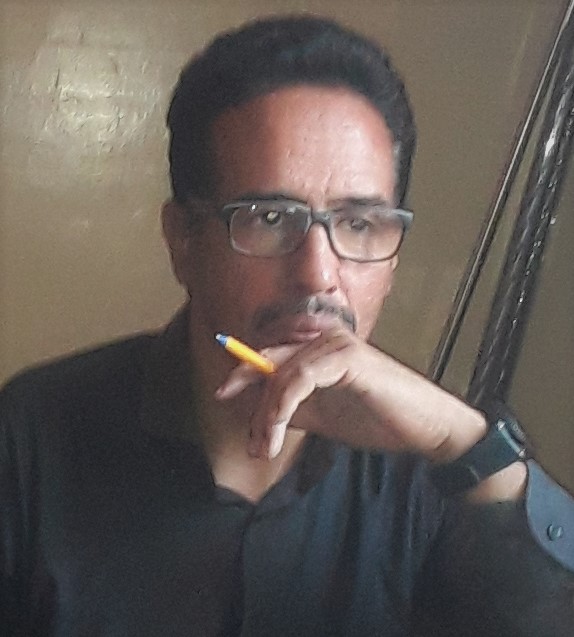التعليم في موريتانيا، الحقائقُ الصادمة… / أمم ولد عبد الله
شهدت هذه الأرض بعد حَجَّة يحيى بن إبراهيم الكدالي في العام 427هــ̸ 1035م، تحولاً نوعياً شمل مجالات الحياة المختلفة، وحدد الأولويات في تراتبية جديدة، أحدثت قطيعة ابستمولوجيوجية، مع ماضي القبائل الصحراوية، تلك القطيعة التي كانت ومازالت لها تأثيرها البالغ في موريتانيا ما بعد الاستقلال، فمعظم المؤرخين الذين تناولوا تاريخ قبائل صنهاجة قبل قدوم عبد الله بن ياسين ت 541هـ̸ 1059م كابن خلدون وابن الأثير وصاحب كتاب قبائل المغرب، أكدوا انتشار الجهل وغلظة الطبع، وغيرهما من المسلكيات التي تنتجها المجتمعات غير المتعلمة، حيث يصبح العنف أهم محدد لرأس المال الرمزي.
فمنذ ستينيات القرن الحادي عشر الميلادي وحتى نهاية خمسينيات القرن العشرين كانت مخرجات التعليم تتم وفق تقليد ديني صار يمنح أصحابه مكانة اجتماعية خاصة، لذلك ليس من الغريب أن نرى إقبالًا على دراسة اللغة والفقه والمنطق والبيان وحتى سر الحرف وغيرهم من العلوم التي كانت تحظى باهتمام فئات عريضة من المجتمع.
بيد أن هذا الاهتمام خلق نخبة من المتعلمين نافست أقرانها من العلماء في أعرق الحواضر الإسلامية مثل فاس والقيروان والقاهرة …، ويوضح ددود ولد عبد الله في كتابه “الحركة الفكرية في بلاد شنقيط حتى نهاية القرن 12 هـ ̸ 18م” مدى التحول الثقافي الكبير الذي أحدثه الشناقطة من خلال اهتمامهم بالتأليف في شتى أصناف المعرفة، والحق أن هذا الاهتمام ساهم من جهته في خلق هُوية لمجتمع الرحل كانت عصية على الاختراق من قبل منظومة التعليم الإفرانكوفوني، لدرجة أنها شكلت صدمة للفرنسيين الذين اعتقدوا أنهم أمام مجتمع هش لا يملك آليات الصمود أمام المد الحضاري القادم من الغرب.
ثمة بعض الحقائق المستعصية على الفهم، وهي أن معظم برامج إصلاح التعليم في البلد، منذ 1967 إلى 1999 لم تستغل رصيداً هُوياتيًا انصهرت فيه ساكنة المجال الممتد من أزواد إلى الساقية الحمراء ومن فوته العليا إلى نهر النيجر، ولفترة زمنية قاربت تسعة قرون، لمواجهة بعض الاختلالات الناجمة عن أطماع المجتمعين في مؤتمر برلين في العام 1884م، لذلك لم يكن الإصلاح التربوي في موريتانيا نابعاً من حاجة ماسة إلى تجاوز التحديات الكبرى المتمثلة في الهُوية وترسيخ اللحمة المجتمعية وخلق إنسان قادر على استغلال موارده الطبيعية المتنوعة، ثم الانتقال إلى مرحلة الاستثمار في اقتصاد المعرفة، فقد بدا أصحاب القرار مجبرين بعد أحداث 1965 على تسييس العملية التربوية وتطويعها لتستجيب لأجندات بعينها، بدل أن تكون داعمة لتجاوز كل الخلافات المُحرَّكة من وراء حجاب.
ففي عام 1979 أقرت الدولة إصلاحاً تربويًا يريد لموريتانيا أن تكون بهويتين، دون مراعاة لما سيترتب على ذلك من مخاطر على مستويات قريبة، وليست أحداث 1989 إلا نتائج طبيعة لهذه الارتجالات التي تتحكم السياسة في بوصلتها أكثر من المصالح العليا للوطن، ويكفي أن هذا الإصلاح لم ينتج سوى نقاش بيزنطي بين نخبة هدفها هو إذكاء الصراع القائم على إقصاء المنافس سبيلا لإثبات الأحقية في وطن يسع الجميع.
المفارقة أنه ومع كل برنامج جديد للإصلاح يزداد تعميق الخلاف أكثر بين مكونات الشعب الواحد، ويتحول التعليم إلى أهم وسيلة لدعم التفرقة وترسيخ التخلف، فقد جاء إصلاح 1999 ليكلف الدولة ملايير الأوقية من خلال دفعها في شكل رواتب لمجموعة من الأساتذة الذين أصبحوا فجأة غير قادرين على أداء مهامهم بسبب عدم تمكنهم من تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وكهذا حول عامل الندرة المواد العلمية إلى سلعة لم تعد متاحة لكل الموريتانيين، الأمر الذي ساهم في بروز نوعين من المدارس (مدرسة للفقراء ومدرسة للأغنياء) شكلت قطيعة بين جيل واحد وتسببت في إنشاء قومية ثالثة ترى أن الهدف الحقيقي هو تكريس تهميشها وإقصائها وصارت المظلومية الشرائحية، التي كان من المفروض أن تختفي في ظل تعليم جيد، جزءاً من الخطاب السياسي.
اليوم وبعد خمس سنوات من الحديث عن المدرسة الجمهورية تسارعت وتيرة الهجرة إلى الدول المجاورة في أوساط الأسر بحثاً عن تعليم نوعي لأبنائهم، ففي تسجيل صوتي متداول لأحد الآباء تحدث فيه عن استغرابه من تحول مدينة سينلويس السنغالية إلى حي من أحياء نواكشوط الشمالية، تسكنه غالبية من قومية تدعوا لتعريب التعليم في العلن، لكنهم مع ذلك فضلوا الإقامة في دولة مجاورة لتعليم أبنائهم بلغة موليير، وتلك ظاهرة تُخفي خلفها هذا التناقض الصارخ الذي يُبرز في أحد جوانبه انعدام الثقة في منظومتنا التربوية، ما جعل البعض يقترح إنشاء وزارة لتسهيل التعليم الابتدائي والثانوي في دول الجوار، بدل إنفاق ميزانيات ضخمة على وزارة تُكرس الإخفاقات ذاتها.
إن إجماع معظم المختصين في المجال التربوي على ضرورة تركيز المنظومات التعليمية في العالم على اللغة الانكليزية باعتبارها لغة العلم، لم يثر اهتمام المعنيين في بلدي بالأمر، بل إن الحديث الآن يرتكزعن إصلاح يعتمد تدريس اللغات الوطنية، وهي خطوة أثارت استغراب أساتذة كبار من أمثال توكا جكانا أستاذ الرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية، الذي اعتبر أن خطوة من هذا القبيل لا تخدم التعليم في موريتانيا، والأمر ذاته نبه له الدبلوماسي أعلي ولد اصنيبه في مقاله الأخير المعنون ب: une année blanche au primaire .
مابين انعدام ثقة الأهالي في التعليم في البلد وحرص الساسة على تسييسه، تبرز حقائق التعليم الصادمة في معظم تمظهراتها ونتائجها وليس التعميم الأخير الحامل الرقم 701 والذي نص على استثناء سبع مدارس أجنبية خاصة، من تطبيق قانون توجيه النظام التعليمي الذي اقتصر التعليم الابتدائي تدريجياً على التعليم العمومي، سوى ارتداد لتلك الصدمات التي ستنتقل للشارع العام في شكل صدام عنيف بين المدرسين وقوات الأمن، وقد تأخذ مسارات أخرى أكثر تعقيداً، لأننا لم نستوعب بعد أن تسييس العملية التربوية مخالف لأبجديات صناعة الأجيال وفق المعايير التي يتطلبها بلد مثل موريتانيا.